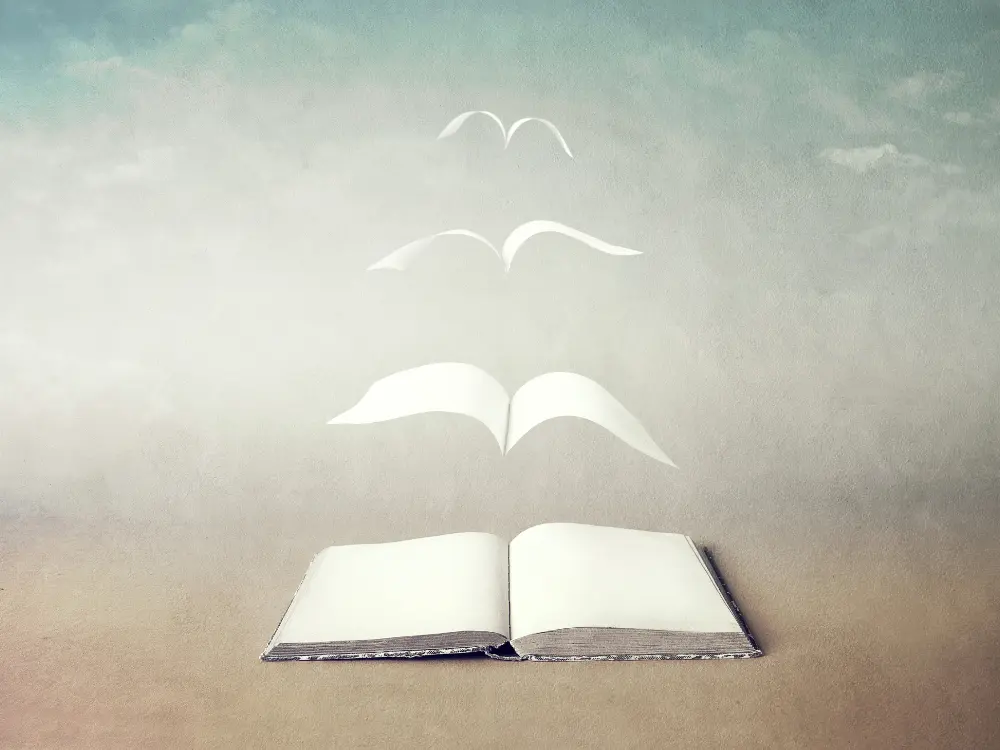يعتبر ديفيد كاودي أن الأخلاقيات التطبيقية هي بمثابة أنموذج للفلسفة التطبيقية، وذلك على اعتبار أنه عند ظهور مصطلح الفلسفة التطبيقية منذ 1970 في مقال يزلي ستيفنسون، عد هذا الأخير الفلسفة التطبيقية فرعا من الأخلاقيات، ما نتج عنه اعتبار عبارتي “الفلسفة التطبيقية” والأخلاقيات التطبيقية مترادفتان.
على هذا الأساس، سعى ديفيد كاودي في هذا المقال، إلى بيان تحديد طبيعة وموضوع ومنحى (المنحى المفروض سلوكه من وجهة نظره) الإبستيمولوجيا التطبيقية عبر توسل المماثلة بين هذه الأخيرة والأخلاقيات التطبيقية.
فأما طبيعة الإبستيمولوجيا التطبيقية، فيزعم كاودي أن الأمر يتعلق بإعادة بعث لتقليد فلسفي تليد: فكما أن الأخلاقيات التطبيقية يمكن النظر إليها باعتبارها استئنافا (منذ السبعينات) لأعمال فلسفية كلاسيكية (أعمال أرسطو وهوبز وتوما الإكويني وكانط وغيرهم)، كذلك، يمكن النظر إلى “الإبستيمولوجيا التطبيقية” باعتبارها طريقة جديدة لتسمية شأن دارج منذ زمن بعيد”. ومن أمثلة ذالك:
– احتجاج جون لوك لصالح التسامح (1689) والذي دار بالأساس حول حدود المعرفة، ويكمن الجانب التطبيقي فيه في كونه يجيب على سؤال كان ملحا في ذاك العصر وفي تلك البقعة الجغرافية، ألا وهو وجوب/إمكانية/حظر اضطهاد الدين المخالف للدين الرسمي.
– كتاب هيوم “في المعجزات” (1748) حول مسألة اعتبار المعجزات الموصوفة في الكتب المقدسة أحداثا تاريخية، والذي يكمن طابعه التطبيقي في أن هذه المسألة كانت قضية خلافية خطيرة خلال القرن 18 الأوروبي.
وعليه، يرى الكاتب أن قسما عظيما مما نعده اليوم إبستيمولوجيا خالصة كان في الآصل إبستيمولوجيا تطبيقية جردت من التطبيق عبر سيرورة من النساوة التاريخية.
وأما عن موضوع الإبستيمولوجيا التطبيقية، فيبدأ الكاتب بالتأكيد على أن بوادر انعطافة تطبيقية للإبستيمولوجيا قد ظهرت بالفعل، ولكن تحت عنوان الإبستمولوجيا الاجتماعية، والتي كانت المقاربة النظرية المهيمنة فيها هي النزعة العواقبية الحقانية. وهنا، يلجأ الكاتب إلى المماثلة بين الإبستيمولوجيا التطبيقية وأخلاق المنفعة الكلاسيكية: ينطلق كاودي من اعتبار تعريف لاري لودان لموضوع الإبستيمولوجيا القانونية “تهتم بما إذا كانت الأنظمة القانونية قد صممت بإحكام لتعزيز الاعتقادات الحقة” باعتبارها فرعا من فروع الإبستيمولوجيا التطبيقية، اعتباره غير كاف ولا يتمتع بما يكفي من العمومية ليغطي موضوع الإبستيمولوجيا التطبيقية. وقد حاول تبيان ذلك من خلال مماثلة الإبستيمولوجيا التطبيقية بالأخلاقيات المنفعية الكلاسيكية، ومن خلال افتراض ادعاء يقول بأن الأخلاقيات التطبيقية عموما تدرس هل صممت الأنظمة الرامية إلى تعزيز السعادة بإحكام يوصل إلى السعادة: يرى الكاتب بأن هذا التعريف غير كاف. أولا لأنه يقتضي إطارا نفعيا (غير مقنع لذوي النزعة غير النفعية)، وثانيا لأنه هناك دائما احتمال لوجود أكثر من قيمة أصلية (السعادة في هذه الحالة) يسعى إلى تعزيزها. وعليه، فإنه يسهل تحويل الاعتراضات المسكوكة ضد النفعية إلى اعتراضات ضد نظيرتها المعرفية، أي الحقانية (التي، ضمن المنظور العواقبي، تعتبر أن القيمة الأصلية الجديرة بالتعزيز هي الحقيقة). ذاك أنه هناك من قد يجادل، من جهة، بوجود قيم أصلية متمايزة عن قيمة الحقيقة ولا تقل أهمية عنها، بل قد تضاهيها كاجتناب الاعتقادات الباطلة (أولائك الذين يفضلون موسوعة بريتانيكا على موسوعة ويكيبديا). ومن جهة أخرى، قد يزعم آخرون أن القيمة الأصلية لاتكمن في الحقيقة بحد ذاتها وإنما في سيرورة اجتلاب أو اجتناب الاعتقادات.
انطلاقا من كل ذلك، يخلص الكاتب إلى أن الإبستيمولوجيا الاجتماعية الحقانية تعد تحديدا ضيقا لما يمكن أن يكون عليه موضوع الإبستيموجيا التطبيقية، وذلك لتركيزها على العواقب المعرفية لأنواع مخصوصة من المؤسسات الاجتماعية، فيما تتجاهل الأسئلة المعرفية ذات البعد الفردي، والتي تعد، رغم ارتباطها بأسئلة السياسة العامة، متمايزة عن هذه الأخيرة بحيث يكون كل تجاهل لها إغفال لنصف الموضوع. ويرى الكاتب أن هذا الإغفال يعود إلى الاتجاه الذي نحاه عدد من الإبستيمولوجيين التحليليين المعاصرين (والذي يرجع إلى ديفيد هيوم) والذي يرى بأن الاعتقادات، عكس الأفعال، لا تتوقف على الإرادة. لقد اعتبر كاودي بأن هذا اعتقاد باطل، حيث يقول بأن الاعتقادات هي أفعال أيضا، ليخلص إلى أن الإبستيمولوجيا التطبيقية لا تشبه الأخلاقيات التطبيقية بل هي فرع من فروعها (وأيضا سابقة عليها منطقيا).
وأما عن المنحى المنشود للإبستيمولوجيا التطبيقية، فيعتقد الكاتب أن المشتغلين بالإبستيمولوجيا التطبيقية ينبغي لهم، إسوة بنظرائهم المشتغلين بالأخلاقيات التطبيقية والذين، بتأثير من التغيرات في البيئة الأخلاقية نهاية الستينات والسبعينات، تجاهلوا نقائض الرؤى الميتا-أخلاقية وانخرطوا في الاستجابة لهذه التغيرات، ينبغي لهم أن يتجاوزوا التحدي الشكي والانطلاق من اعتبار حيازتنا للمعرفية وقدرتنا على الاستزادة منها حقيقة بديهية. ذاك أنه من هنا تبدأ الأسئلة المثيرة والمهمة في الإبستيمولوجيا.